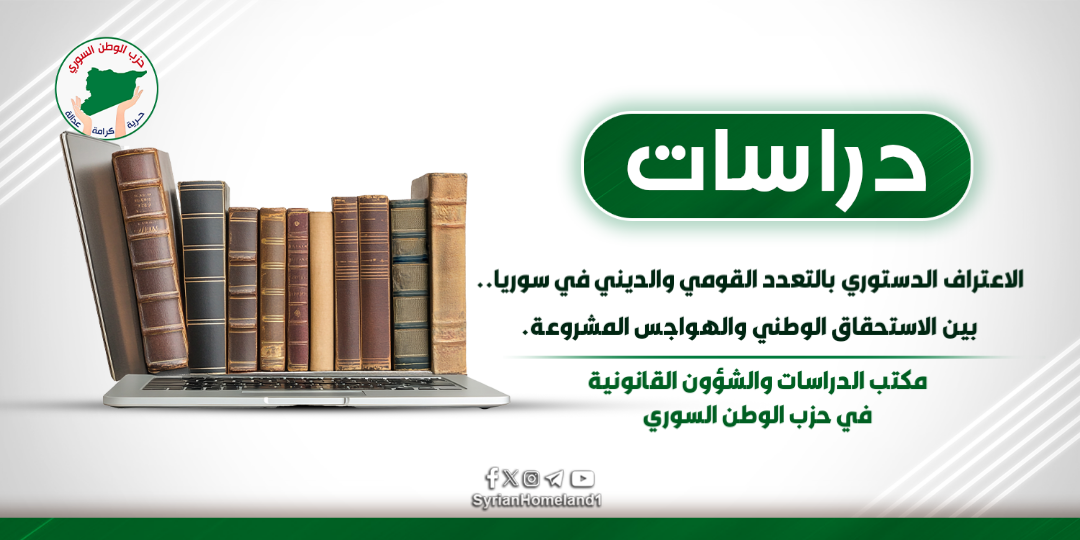المقدمة:
في خضمِّ التحوّلات الجذريّة التي تشهدها سوريا بعد أكثر من عقد من الصراع والانقسام، تبرز مسألة إعادة تعريف هوية الدولة كواحدة من أعقد التحديّات السياسية والدستورية، لقد كشفت السنوات الماضية عن عمق التناقضات البنيوية في تصوّر الدولة الوطنية السورية، خصوصاً فيما يتعلّق بمكانة المكونات القومية والدينية داخل النسيج الوطني،
فالنظام السياسي الذي ساد منذ ستينيات القرن الماضي — والمبني على مركزية قومية عربية أحادية — لم يؤسّس لمواطنة متساوية بقدر ما رسّخ منطق الهيمنة الرمزية والسياسية لمكونٍ واحد على حساب بقيّة الجماعات التاريخية في البلاد “الدولة البعثية عملت على إعادة تشكيل الريف السوري بوصفه حقلاً لضبط الهوية أكثر من كونه مجالاً للإنصاف الطبقي”،
إن الاعتراف الدستوري بالتعدّد القومي والديني، في هذا السياق، لا يمثّل مجرّد ترف لغوي أو نزعة هوياتية عابرة، بل هو استحقاق سياسي وقانوني وأخلاقي يُمكن من بناء عقد اجتماعي جديد، تكون المواطنة فيه جامعة لا مقصية، والتعددية فيه مكوّناً تأسيسياً لا خطراً مهدداً، فالتجربة السورية علّمت الجميع أن تجاهل الهويات، أو التعامل معها كملحقات ثقافية لا كشركاء في الكيان الوطني، يؤدّي في النهاية إلى انفجارات هوياتية تعبّر عن نفسها بالعنف أو الانفصال أو الانكفاء السياسي) وهنا يناقش بشارة المفارقة بين الخطاب القومي العربي والديمقراطية، ويؤكّد أن الهوية القومية الأحادية تقف غالباً في وجه الاعتراف بالتعدد والتنوع، وفي هذا الإطار، تطرح الدراسة إشكالية مركزية مفادها:
هل يمكن للدولة السورية المستقبلية أن تتبنّى مبدأ المواطنة المتساوية دون الاعتراف الصريح بالتعدد القومي والديني؟
وإذا كان الاعتراف مطلوباً، فكيف يمكن أن يتمّ دون تهديد وحدة الدولة أو إثارة هواجس الأغلبية العربية؟ وهل تشكّل المبادرة إلى الاعتراف فعلاً تأسيسياً لعقد اجتماعي تعددي، أم تُحمل لاحقاً بتأويلات قد تُستخدم لأغراض انفصالية أو خارجية؟
تسعى هذه الدراسة إلى تأصيل هذه الإشكالية من خلال ثلاث مستويات تحليلية:
قانوني دستوري، يرصد مدى مشروعية الاعتراف بالتعدّد في ظل مبدأ المواطنة وسيادة القانون، ويقدّم نماذج مقارنة من الدساتير العالمية سياسياً وواقعياً، يحلّل البنية الاجتماعية السورية وتحوّلاتها بعد الثورة، وتبرز الحاجة إلى تصحيح العلاقة بين الدولة والمجتمع في إطار جدلي نقدي، يتناول الهواجس المشروعة التي قد تنشأ، سواء من جهة الأغلبية أو من جهة الخشية من المحاصصة والتدخل الخارجي، ويقترح آليات توازن واستجابة، وتُخصّص الدراسة أيضاً وقفة ضرورية حول المسؤولية التاريخية للأغلبية العربية بصفتها المكوّن الأكثر عدداً في سوريا، والكيفية التي يمكن من خلالها أن تتحوّل هذه الأغلبية إلى ضامن أخلاقي للعدالة التعددية، لا إلى طرف خائف منها، في النهاية لا تنطلق هذه الورقة من نزعة تفتيتية، بل من إيمان عميق بأن الوحدة الوطنية لا تُبنى عبر الإنكار، بل عبر الاعتراف، ولا تترسّخ بالقسر، بل بالشراكة والمواطنة الحقيقية، كما يذهب ياسين الحافظ إلى أنه لا تتحقّق إلا عندما تُصاغ الدولة على صورة مجتمعها لا على صورة جزء منه فقط فيقول: “لقد خنقنا التعدّد خوفاً من الانقسام، فانقسمنا تحت راية الوحدة.”
الفصل الأول: الأساس القانوني والدستوري للاعتراف بالتعدّد.
يرتكز بناء الدولة الديمقراطية الحديثة على مبدأين متكاملين: المواطنة المتساوية وسيادة القانون وبموجب هذين المبدأين، يُفترض أن يتمتّع جميع الأفراد بالحقوق ذاتها، دون تمييز قائم على القومية أو الدين أو اللغة أو أي انتماء آخر، غير أن هذا التصور وإن بدا مثالياً في المجتمعات المتجانسة، يواجه تحديات عملية في الدول ذات التركيب المتعدد، كما هي الحال في سوريا، ومن هنا تنشأ الحاجة إلى تحليل ما إذا كان الاعتراف الدستوري بالتعدّد القومي والديني يتعارض مع مبدأ المواطنة، أم يُعدّ شرطاً لتحقيقها، خاصة في السياقات التي شهدت تمييزاً مؤسسياً وإنكاراً للهوية لفئات من السكان، سنتناول هذه المسألة من خلال ثلاث مستويات:
1. المواطنة والتعدّد في الفقه الدستوري
في الفكر الدستوري المقارن يتم التمييز بين:
المواطنة المتساوية: وتعني المساواة أمام القانون في الحقوق والواجبات.
المواطنة الشاملة أو الجامعة: وهي التي تتّسع لتضم تنوّع المجتمع وتحميه، ولا تفرض هوية واحدة مهيمنة، وقد تطوّر هذا الفهم في دساتير ما بعد النزاعات، حيث لم تعد الدولة المحايدة إثنياً ممكنة أو عادلة دائماً، بل ظهرت حاجة إلى اعتراف قانوني صريح بالهويات المتعدّدة، من باب تحقيق المساواة الفعلية، لا الشكلية فقط
على سبيل المثال، يُقر الفقهاء المعاصرون بأن “التجاهل الدستوري للهويات الفرعية في الدول المركّبة لا يفضي إلى وحدة، بل إلى احتقان مكتوم يتفجّر عند أول فرصة”، وهذا ما يفسّر التوجّه المتزايد نحو إدماج الاعتراف بالتنوّع ضمن المبادئ الدستورية، لا فقط في فصول الثقافة أو الحقوق الفردية.
2. التجارب الدستورية المقارنة:
أ. العراق: في دستور العراق لعام 2005، نصّت المادة 3 صراحة على أن:
“العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب، وهو جزء من العالم الإسلامي”.
هذا الاعتراف لم يكن ترفاً، بل جاء نتيجة قطيعة تاريخية بين الدولة المركزية والمكونات غير العربية، لا سيما الكرد، وقد أسّس هذا النص لشرعية وجودية لمكونات كبرى، وفتح الباب أمام ترتيب إداري (كإقليم كردستان) دون مساس نظري بوحدة الدولة.
ب. كندا: في كندا، وعلى الرغم من أغلبية ناطقة بالإنجليزية، يُعترف دستورياً بالفرنكوفونية كشعب مؤسّس، وباللغتين الرسميتين (الإنجليزية والفرنسية)، بل إن ميثاق الحقوق والحريات الكندي (1982) يعترف أيضاً بحقوق “الشعوب الأصلية” (First Nations) بشكل صريح، من باب العدالة التصحيحية، وليس المحاصصة.
ج. جنوب إفريقيا: بعد نهاية الأبارتايد، جاء دستور 1996 ليعترف بـ 11 لغة رسمية، وبأن جنوب إفريقيا “تنتمي لجميع من يعيشون فيها، متحدين في تنوعهم”. لقد كان الاعتراف بالتنوع عنصراً تأسيسياً لبناء دولة حديثة تتجاوز الانقسام العرقي، لا تهرب منه.
3. المرجعيات القانونية الدولية:
تؤكّد المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على الحق في التمايز الثقافي والقومي، ومنها:
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966):
“لا يجوز حرمان الأشخاص المنتمين إلى أقليات من حقّهم في التّمتّع بثقافتهم، أو المجاهرة بدينهم، أو استخدام لغتهم.” (المادة 27)
إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات (1992):
يدعو الدول إلى اتخاذ “تدابير مناسبة لتمكين الأقليات من التعبير عن خصائصهم، وتنميتها.”
هذه النصوص تُظهر أن الاعتراف القانوني والدستوري بالتعدّد القومي والديني ليس مخالفاً لمبادئ المساواة، بل هو وسيلة لتحقيقها بشكل عادل وشامل، خصوصاً عندما تتراكم مظالم تاريخية ضد جماعات بعينها.
خلاصة :
• الاعتراف الدستوري بالتعدّد لا يتناقض مع مبدأ المواطنة المتساوية، بل يُكمّلها.
• الدول المتنوّعة التي فشلت في الاعتراف الصريح بتعدّدها غالباً ما واجهت أزمات وطنية متكررة.
• التوجه العالمي اليوم ليس نحو إلغاء الهويات من أجل الدولة، بل نحو إدماجها في بنيتها التأسيسية بطريقة تحفظ الوحدة وتُعزّز الشراكة.
الفصل الثاني: الواقع السّوري وضرورات الاعتراف بالتعدّد.
لم تكن الأزمة السورية التي تفجّرت في عام 2011 مجرّد انتفاضة ضد الاستبداد السياسي، بل كانت أيضاً لحظة كشف عميق للهشاشة البنيوية في تصوّر الدولة السورية لهويتها الوطنية، فقد بدا واضحاً أن التصور الذي ساد منذ الاستقلال، وخصوصاً بعد انقلاب حزب البعث عام 1963، قام على إنكار التعدّد القومي والديني، ومحاولة صهر المجتمع السوري في هوية عربية أحادية تحت شعار “أمّة عربيّة واحدة”، وهو ما انعكس في البنية الدستورية، والسياسات التعليمية والإدارية، وحتى في إنتاج الرموز الوطنية، هذا الفصل يُبيّن أن الاعتراف الدستوري بالتعدّد لم يعد خيار رفاهية، بل ضرورة سياسية وقانونية وتاريخية، تمليها التحوّلات العميقة في وعي الجماعات السورية بهوياتها، وفي توازنات القوة بعد الثورة.
1. تاريخ من التهميش والإنكار الممنهج
أ. الحالة الكردية:
منذ إحصاء الحسكة عام 1962، جُرّد عشرات الآلاف من الأكراد من الجنسية السورية، ما حرمهم من التعليم، التوظيف، والتملّك،
مُنعت اللغة الكردية من التداول الرسمي، وجرى تغيير أسماء القرى والمدن الكردية ضمن سياسة “تعريب” ممنهجة،
لم يرد ذكر الأكراد في أي من دساتير الجمهورية الثانية (بعد 1963)، رغم أنهم ثاني أكبر مكوّن قومي في البلاد.
ب. السريان والآشوريون والأرمن:
أُدرجت هذه المكونات ضمن خانة “الطوائف المسيحية”، دون الاعتراف بكونها شعوباً ذات لغات وثقافات مستقلة،
لم يُعترف باللغات السريانية أو الأرمنية في النظام التعليمي أو الثقافي الرسمي،
غالباً ما قُدّمت هذه الجماعات بوصفها “ضيوفاً حضاريين”، لا شركاء أصليين.
ج. الطوائف الدينية والمذهبية:
بينما استفادت الطائفة العلوية من وصول حافظ الأسد إلى الحكم، فإن سائر الطوائف، بما فيها السنة، لم تُعامل كمكوّن ديني متكافئ، بل خضعت جميعها لمنطق أمني سلطوي، غيّب تمثيلها السياسي الحقيقي.
لم تنص الدساتير السورية على أي شكل من الحماية لحقوق الجماعات الدينية كجماعات، بل فقط كأفراد.
2. تحوّلات ما بعد 2011: من الهوية المفروضة إلى الهوية المتفاوض عليها، ومع اندلاع الثورة وتفكّك قبضة الدولة المركزية على معظم الجغرافيا السورية، بدأت المكونات المهمّشة تعبّر عن هويتها خارج الإطار الرسمي، بل وتبني نماذج حكم ذاتي أو إدارات محلية تعبّر عن لغتها وثقافتها وهواجسها.
أبرز التحولات:
• تجربة الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا، التي اعتمدت اللغات الكردية والعربية والسريانية كلغات رسمية.
• ظهور المجالس المحلية التي ضمّت تمثيلات طائفية ومناطقية أوسع.
• انتقال الخطاب السياسي لدى أغلب المكونات من المطالبة بـ”حقوق ثقافية” فقط، إلى المطالبة بالاعتراف الدستوري كشركاء أصليين.
هذه التحوّلات أظهرت أن الدولة السورية المستقبلية، إن أرادت البقاء موحّدة، عليها أن تُعيد تعريف ذاتها بطريقة تعترف رسمياً بتعدّدها، لا أن تُكرّر صيغ الهيمنة القديمة.
3. الاعتراف كشرط للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية
لا يمكن بناء عقد اجتماعي سليم بعد حرب أهلية دون أن يتم الاعتراف بالمظالم السابقة، لا سيما التمييز القومي والديني الممنهج، وهذا الاعتراف لا يُعالج فقط عبر المحاكم أو لجان الإنصاف، بل يجب أن يُترجم إلى نصوص دستورية ضامنة،
إن الاعتراف بالتعدّد لا يعني تقسيماً، بل يشكّل صمّام أمان ضد التقسيم، فالجماعات التي تُحترم هويتها داخل الدولة، تجد مصلحة في البقاء ضمنها، لا في الانفصال عنها،
كما يؤكّد الفقيه الدستوري الجنوب أفريقي ألون ليجو، فإن “الهوية التي لا تُرى في الدستور، تُراكم الغضب ضد الدولة”،
إنكار التعدّد القومي والديني لم يكن مجرّد غياب في النص، بل سياسة ممنهجة ساهمت في إنتاج التهميش والانفجار،
بعد الثورة أصبح من الواضح أن المكونات السورية تطالب بمكانة دستورية صريحة، لا فقط بالحماية من التمييز،
الاعتراف بهذه المكونات، كلٌّ بحسب خصوصيته، سيكون بمثابة المدخل الحقيقي لأي مصالحة وطنية عادلة ودائمة.
الفصل الثالث: الهواجس المرتبطة بالاعتراف الدستوري بالتعدّد – تفكيك ومقاربات.
يشكّل موضوع الاعتراف الدستوري بالتعدّد القومي والديني أحد أكثر قضايا الإصلاح الدستوري إثارة للجدل في الحالة السورية، نظراً لتاريخ طويل من المركزية القومية والهيمنة الثقافية، وما ترتّب عليها من تهميش للمكونات غير العربية وغير المسلمة السنية، إلا أن السعي نحو دستور جديد يعكس التعدّد الفعلي في المجتمع السوري يواجه بجملة من الهواجس والمخاوف، التي تتراوح بين الاعتبارات السياسية والثقافية والأمنية، في هذا الفصل نسعى إلى تفكيك هذه الهواجس وتحليل خلفياتها، تمهيداً لتقديم مقاربات واقعية في الفصل اللاحق تساهم في تجاوزها ضمن إطار دستوري جامع.
1. الخوف من التقسيم والانفصال
من أبرز المخاوف التي تبرز عند الحديث عن الاعتراف الدستوري بالمكونات القومية، خصوصاً في ما يتعلّق بالقضية الكردية، هو احتمال أن يتحوّل هذا الاعتراف إلى بوابة للانفصال أو التقسيم، ويستند هذا القلق إلى تجارب إقليمية، أبرزها تجربة إقليم كردستان في العراق، حيث وُجّهت اتهامات متكرّرة للإقليم باستخدام الفدرالية كجسر نحو الاستقلال، خصوصاً بعد الاستفتاء على الانفصال في سبتمبر 2017، كما يُعزّز هذا التخوّف تصريحات سابقة لبعض القوى الكردية السورية حول “الحق في تقرير المصير”، حتى وإن جاءت هذه التصريحات بصيغ مرنة أو غير ملزمة، غير أن هذا الخوف وإن كان مفهوماً، ليس قدراً لا يُمكن تجاوزه، فالتجارب الدولية تُظهر أن الاعتراف بالهوية لا يؤدي بالضرورة إلى الانفصال، بل قد يكون أداة لتعميق الانتماء الوطني، كما في حالة إقليم كتالونيا في إسبانيا، رغم التوترات التي شهدها الإقليم لاحقاً، حيث حافظت الدولة على وحدتها عبر أدوات دستورية متقدّمة تجمع بين الاعتراف والضبط،
المدخل الواقعي لتجاوز هذا الخوف هو بناء عقد دستوري ذكي يربط الاعتراف بالهوية القومية بوحدة الدولة، وينص صراحة على أن التنوّع لا يُبرّر الانفصال، بل على العكس، فإن الإنكار هو ما يدفع بالمكونات نحو طلب الانفصال، بينما الاعتراف يحوّل الدولة إلى فضاء مشترك ينتمي إليه الجميع طوعاً، لا قسراً.
2. القلق من تهديد الهوية العربية.
ثمّة قلق آخر يتكرّر في الخطاب العام لبعض المثقفين والفاعلين السياسيين العرب، يتمثّل في الخشية من أن يؤدي الاعتراف الدستوري بالتعدّد إلى تفكيك الطابع العربي لسوريا أو تحجيم الثقافة العربية، هذا القلق وإن بدا مفهوماً في سياق هيمنة الخطاب العروبي لعدة عقود، إلا أنه يقوم على خلط شائع بين الهوية الجامعة للدولة، التي يُفترض أن تكون تعدّدية، وبين الثقافة الأكثر انتشاراً التي لا ينتقص منها حين تُفسَح مساحة لغيرها،
لقد أشار المفكّر المغربي عبد الله العروي إلى هذا الإشكال في ربط الثقافة بالهوية السياسية، محذراً من أن تسييس الثقافة يؤدّي إلى إقصاء بقية المكونات وتحميل لغة أو ثقافة معيّنة عبء الهيمنة والتهميش، من هذا المنظور، فإن الاعتراف ببقية المكونات لا يُضعف الثقافة العربية، بل يُحرّرها من أعباء الإقصاء ويفتح المجال لتحوّلها إلى لغة شراكة وتعدّد، بدلاً من أن تبقى رمزاً لهيمنة قومية أحادية، كما تُظهر تجربة تونس بعد الثورة إمكانية بناء دولة تعترف بالتعدّد الثقافي دون أن تُنكر انتماءها العربي، فقد نص دستور 2014 على الهوية العربية الإسلامية للدولة، لكنه ألزمها في الوقت نفسه باحترام المكونات الثقافية الأخرى، ما يدل على قابلية الدمج بدلاً من النفي.
3. التحذير من المحاصصة الطائفية أو القومية.
يتردّد التحذير من أن الاعتراف الدستوري بالتعدّد قد يفتح الباب أمام محاصصة سياسية أو تقاسم سلطوي على أساس المكونات، كما هو الحال في لبنان أو العراق. ويُخشى أن يؤدّي ذلك إلى إضعاف الدولة وتعميق الانقسامات، بدلاً من تجاوزها،
هذا التحذير مشروع، لكنه لا يُبرّر رفض الاعتراف بالتعدد، فالتجربة تُثبت أن الخطر لا يكمن في الاعتراف بحد ذاته، بل في كيفية تنظيمه وتطبيقه، فهل يتم ذلك من خلال نظام تمثيل ثابت ومحاصصي؟ أم ضمن إطار من المواطنة المتساوية والضمانات الثقافية المرنة؟
الدرس الأهم هنا يأتي من تجربة جنوب إفريقيا، حيث اعترف دستور 1996 بالتعدّد العرقي والثقافي دون أن يؤسّس على ذلك تمثيلاً سياسياً مغلقاً على أسس هوياتية، بل تم تنظيم الحياة السياسية على أساس المواطنة، ضمن مبدأ “الوحدة في التنوّع” (South African Constitution, 1996). وهذا ما يُفترض أن يشكّل قاعدة لأي صياغة دستورية سورية، تضمن التنوّع دون أن تشرّع تقاسم الدولة.
4. الخوف من تدويل الهويات
يبرز هذا التخوّف بشكل خاص في الحالة السورية، حيث كانت التدخلات الخارجية غالباً ما تستخدم ذريعة حماية المكونات كمدخل لتبرير التدخل السياسي أو العسكري، ويُخشى من أن يؤدي الاعتراف الدستوري بالقوميات أو الأديان إلى تكريس هذه الذريعة أو فتح أبواب جديدة أمام التدويل،
غير أن هذا الخوف كما أشار فرانسيس دينغ في دراسته حول “الهوية والسيادة في الدول المتعدّدة القوميات”، يجب أن يُوجَّه إلى سياسات الدولة المركزية التي تفشل في حماية التعدّد داخلياً، لا إلى الحقوق المشروعة للمكونات، فالهوية لا تُستدعى إلى الخارج إلا عندما تُقمع في الداخل، والعلاج لا يكون بإنكارها، بل باحتضانها ضمن المشروع الوطني الجامع.
خلاصة
تُظهر هذه القراءة أن الهواجس المرتبطة بالاعتراف الدستوري بالتعدّد حقيقية، لكنها ليست حتمية ولا غير قابلة للمعالجة، بل إن التجارب الدولية، بما فيها تلك التي فشلت، تؤكد أن الإقصاء لا يقلّ خطراً عن المحاصصة، وأن الإنكار يغذّي التدويل تماماً كما قد تفعل المبالغة في التمثيل الهوياتي،
إن الحل الواقعي لا يكون بإنكار التعدّد، بل بإدارته ضمن إطار دستوري عادل، يدمج الهويات دون أن يُقسّم الدولة إلى حصص، ما تحتاجه سوريا هو عقد سياسي جديد يُبنى على أساس المواطنة التعددية، ويضمن لكل مكوّناته حق الحضور، لا حق الهيمنة، وحق التعبير، لا حق الانفصال.
الفصل الرابع: في المسؤولية التاريخية للأغلبية لبناء وطن تعددي.
حين تمر الدول بتحوّلات سياسية عميقة، خصوصاً تلك الخارجة من نزاعات طويلة أو أنظمة سلطوية، فإن مسؤولية إعادة بناء العقد الوطني لا تقع فقط على النخب أو الجماعات المهمّشة، بل أيضاً – وربما أوّلاً – على الأغلبية القومية أو الثقافية التي تمتّعت بمركزية رمزية أو سلطوية داخل الدولة،
وقد أظهرت التجارب الدولية أن ما يُسمى “الديمقراطية التعدّديّة” لا تتحقّق فقط بإعادة توزيع السلطة، بل باستعداد الأغلبية لتحمّل مسؤولية أخلاقية وتاريخية، تجعل من حضورها رافعة للمصالحة، لا عقبة في وجهها،
في الحالة السورية، حيث يشكّل العرب السنة النسبة الأكبر سكانياً (تقديرياً بين 70% إلى 80%)، تتّجه الأنظار نحو هذا المكوّن، ليس بوصفه متّهِماً، بل بوصفه القادر على تأسيس تصوّر جديد لسوريا، يتجاوز مركزية العروبة الأحادية نحو وطن تتشارك فيه كل الهويات،
ويُفترض أن يشكّل هذا التحوّل مبادرة سياسية مسؤولة، لا تنازلاً مفروضاً، لأن من يمتلك المركز الرمزي هو من يملك مفاتيح الطمأنة.
1. الأغلبية كفاعل تاريخي: بين المركزية القديمة وفرصة البناء الجديد.
لقد رسّخت الأنظمة المتعاقبة في سوريا، وخصوصاً بعد استلام حزب البعث للسلطة عام 1963، تصوراً للدولة يقوم على احتكار العروبة لهوية الدولة الوطنية،
فالدساتير المتعاقبة نصّت بوضوح على أن سوريا “جزء من الأمة العربية”، ولم تأتِ على ذكر المكونات الأخرى كشركاء في الهوية، بل اختزلت التنوّع في مسألة طائفية أو لغوية ثانوية،
هذا النموذج فشل في إنتاج وطن موحّد، وفتح الباب أمام انفجارات هوياتية لاحقة يخشى أن تكرّر تجارب دولية كارثية كما حدث في يوغوسلافيا السابقة مثلاً، اذ أدّى إصرار الصرب على مركزية هويتهم القومية في تعريف الدولة إلى إشعال سلسلة من الحروب والانفصالات، رغم أن الصرب كانوا يشكّلون الأغلبية،
وفي المقابل أظهرت تجربة جنوب إفريقيا مثالاً مضادّاً، حيث أدركت الأغلبية السوداء بعد نهاية الأبارتايد أن العدالة الانتقالية لا تقوم على الانتصار، بل على الشراكة، فوافق المؤتمر الوطني الإفريقي على نصوص دستورية تعترف بحقوق البيض كأقلية ثقافية، وضمنت لهم التمثيل اللغوي والتعليمي، رغم الإرث الاستعماري الثقيل.
2. التنازلات البنّاءة كقوّة لا كضعف، يُنظر أحياناً داخل المجتمعات ذات الأغلبية الصلبة إلى أي اعتراف بالتعدّد على أنه “تنازل غير مبرّر”، أو حتّى تهديد للهوية العامة،
لكن هذا التصوّر يغفل عن أن الاعتراف بالتعدّد لا يُضعف الأغلبية، بل يحرّرها من عبء الإقصاء والمسؤولية، ويفتح المجال أمامها للقيام بدور القيادة الأخلاقية،
كما يقول المفكّر الكندي ويل كيمليكا:
“إن القوّة الأخلاقية للأغلبية لا تُقاس بقدرتها على فرض هويتها، بل باستعدادها للاعتراف بالآخر، وضمان مشاركته في بناء الوطن.”
في السياق السوري، لا يعني الاعتراف بالكرد أو السريان أو الأرمن أو غيرهم تقليصاً للعروبة، بل يعني انتقال العروبة من هوية مهيمنة إلى هوية شريكة، ومن مركز قلق إلى مركز طمأنة.
3. من الخوف إلى الطمأنة: واجب الأغلبية في لحظة التأسيس
المكوّنات القومية والدينية السورية لا تطالب فقط بحقوق ثقافية، بل تطالب باعتراف دستوري يضمن لها مكانة سياسية ورمزية داخل الدولة،
وهنا لا يكفي أن تقبل الأغلبية بهذا الواقع، بل عليها أن تبادر إلى طمأنة الجميع بأن ما حدث سابقاً لن يتكرّر،
هذه المسؤولية لا يمكن تحميلها لجماعات صغيرة بلا أدوات، بل تقع على من يملك الغالبية الرمزية والسياسية،
ففي تجارب مثل رواندا بعد الإبادة الجماعية، لعبت الأغلبية الهوتو، رغم ماضيها الإجرامي، دوراً رئيسياً في إعادة الاعتبار للتوتسي، عبر صياغة خطاب وطني تعدّدي حاسم في دستوره عام 2003 .
4. القيادة الأخلاقية لا تُفرض بل تُمارَس.
قيادة الأغلبية لمرحلة انتقالية ناجحة لا تعني السيطرة على القرار، بل فتح المجال لصوت الجميع في كتابة العقد الجديد، ولا تعني امتيازاً بل مسؤولية
وهذه القيادة تُترجم عبر:
• الاعتراف العلني بالمظالم التاريخية.
• دعم الاعتراف الدستوري بالتعدّد الثقافي واللغوي.
• ضمان التمثيل السياسي المتساوي دون منطق محاصصة.
وكما تؤكّد “اللجنة الدولية المعنية بالديمقراطية والعدالة في المجتمعات المتعددة”:
“إن استقرار الدولة لا يأتي من تماثل مكوناتها، بل من إدارتها العادلة للاختلاف.”
إن إعادة بناء سوريا لا تستلزم فقط توافقاً سياسياً، بل تحولاً أخلاقياً في دور الأغلبية،
ولا تُبنى الوحدة عبر القوة أو الأغلبية العددية، بل عبر الثقة، والاعتراف، والمبادرة إلى الإنصاف،
وهكذا، لا يكون العرب في سوريا مجرّد مكون أكبر، بل رسل تأسيس لوطن يتّسع للجميع، يُشبههم ويشبه شركاءهم.
الفصل الخامس: الاستجابات القانونية والسياسية الممكنة
في مواجهة هواجس الأغلبية، ومطالب المكونات القومية والدينية المهمشة.
وفي ظل الإرث الثقيل الذي خلّفته عقود من الإنكار والهيمنة، تبرز الحاجة إلى استجابات دستورية وقانونية متوازنة، تعترف بالتعدّد وتحميه، دون أن تسقط في فخ المحاصصة أو تهدّد وحدة الدولة،
تسعى هذه الاستجابات إلى التوفيق بين مبدأ المواطنة المتساوية، وواقع التعدّد القائم، عبر آليات مؤسّسية ونصوص واضحة تضمن الحقوق وتبني الثقة،
هذا الفصل يعرض أربعة مستويات من هذه الاستجابات، مستفيداً من التجارب المقارنة وسياق الواقع السوري:
1. الصياغة الدستورية المتوازنة: الاعتراف دون تهديد.
أوّل ما ينبغي فعله هو تجاوز الصياغات المموّهة التي تنكر التعدّد باسم الوحدة، أو تكرّس الهيمنة باسم الأغلبية،
بدلاً من ذلك، تُصاغ مقدمة الدستور، أو باب المبادئ العامة، بلغة تعترف صراحة بأن:
“سوريا دولة مدنية ديمقراطية، متعدّدة القوميات والثقافات، تقوم على المواطنة المتساوية، وتضم العرب، الكرد، السريان، الآشوريين، الأرمن، التركمان، الشركس وغيرهم من المكونات الأصيلة.”
هذه الصيغة تُشبه ما ورد في دستور جنوب إفريقيا (1996)، حيث نصّت المقدمة على:
“نحن شعب جنوب إفريقيا، متّحدون في تنوّعنا، نكرّس هذا الدستور كعلامة على المصالحة الوطنية والعدالة.”
2. الإقرار باللغات والثقافات ضمن إطار قانوني.
لا يمكن لمكوّن أن يشعر بالانتماء إلى دولة تقصي لغته أو ثقافته من الفضاء العام، ولهذا يجب أن يُنص في الدستور على: (اللغة العربية كلغة رسمية للدولة)،
مع الاعتراف بلغات الكرد والسريان والأرمن وغيرهم كلغات وطنية، تستخدم في مناطقها، ويكفل التعليم بها، كما في النموذج الإسباني (الكتالونية والباسكية والغاليثية) أو النموذج الكندي (الفرنسية في كيبيك)
كما يمكن أن يتضمّن الدستور مادة مشابهة لما ورد في المادة 4 من دستور العراق (2005):
“تضمن الدولة الحقوق الإدارية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة، بما فيها الحق في التعليم بلغتها الأم.”
3. إعادة تشكيل الرموز الوطنية لتكون جامعة.
جزء كبير من التوترات القومية في سوريا ينبع من الطابع الأحادي للرموز الوطنية: علم الدولة، أسماء الشوارع، الأعياد الرسمية، المناهج التعليمية… لذا، يجب العمل على:
• إعادة صياغة مناهج التعليم لتعكس كل المكونات الثقافية في سوريا
• السماح باستخدام الرموز الثقافية المحلية (الملابس، الاحتفالات، الأعلام الثقافية) ضمن الفضاء العام
• الاعتراف المتبادل بين رموز الهويات الثقافية كجزء من تراث وطني مشترك.
• تترجم هذه الخطوات اعترافاً فعلياً، لا فقط نصوصاً جامدة.
4. ضمان التمثيل السياسي العادل دون الوقوع في المحاصصة.
التمثيل السياسي يجب ألا يقوم على الانتماء الهوياتي وحده، بل على التمكين السياسي للجميع عبر المواطنة، لكن هذا لا يمنع من اتخاذ تدابير مرحلية لضمان عدم إقصاء أي مكوّن.
تشمل هذه التدابير:
• تعديل قانون الانتخابات ليفسح المجال لقوائم تمثّل التنوع القومي والثقافي.
• تخصيص مقاعد تمثيلية للمكونات التي تعرّضت لتهميش طويل، كما في نموذج “الدوائر الثقافية” في بعض دول أميركا اللاتينية .
• إنشاء مجالس استشارية ثقافية داخل البرلمان، تمثّل المكونات القومية والدينية، بصوت غير تشريعي لكن مؤثّر،
أخيراً فإن الاعتراف الدستوري بالتعدّد يجب أن يُترجم إلى نصوص قانونية، وممارسات مؤسّساتية، وآليات ثقافية،
لا يكفي أن تقول الدولة إنها تعدّديّة، بل عليها أن تجعل كل مكوّن يرى نفسه فيها، لغوياً، ورمزياً، وسياسياً،
يمكن لسوريا إن استوعبت دروس التجارب المقارنة، أن تنتقل من دولة الإنكار إلى وطن التعدّد العادل، دون أن تتفكّك أو تتنازل عن وحدتها.
الخاتمة: نحو عقد وطني سوري يقوم على الاعتراف العادل والشراكة المتوازنة
تُبيّن هذه الدراسة، عبر تتبّعها للأطر القانونية المقارنة، والسياق السوري الخاص، أن الاعتراف الدستوري بالتعدّد القومي والديني لا يُشكّل تهديداً لوحدة الدولة، بل شرطاً لتأسيسها على أسس من العدالة والمواطنة المتساوية،
لقد أظهرت التجارب الدولية أن الدولة الوطنية الحديثة لا تُبنى بإنكار الواقع الثقافي والاجتماعي، ولا بتغليب مكوّن على آخر باسم “الأغلبية الطبيعية”، بل بخلق مساحة قانونية وأخلاقية جامعة، تحمي التعدّد دون أن تقسّم السيادة، وتكرّس التّنوّع دون أن تفكّك الدولة،
وبينما تبنى المواطنة على المساواة أمام القانون، فإن المساواة لا تعني التشابه، بل العدالة في التعامل مع الاختلاف،
في السياق السوري، تُطرح هذه الضرورة ضمن معادلة أكثر تعقيداً:
فالأغلبية العربية، بما تحمله من إرث مركزي، تُدعى اليوم إلى قيادة تأسيسية جديدة، لا تعيد إنتاج هيمنة ثقافية أو لغوية، بل تبادر إلى إعادة تعريف الوطن كمجال مشترك، لا كمِلكية رمزية لمكون بعينه،
وهذه ليست تنازلات، بل هي فعل سياسي وأخلاقي يُحرّر الأغلبية ذاتها من إرث الإقصاء، ويمنحها مشروعية جديدة قائمة على الطمأنة والشراكة،
من جهة أخرى، فإن الاعتراف بالمكونات القومية والدينية لا يجب أن يُقرأ كدعوة لمحاصصة أو فدرلة هوياتية، بل كخطوة دستورية نحو مجتمع ديمقراطي تعدّدي، تكون فيه الهوية الوطنية مركّبة من روايات متعدّدة تتشارك في بناء الدولة.
التوصيات الختامية:
1. نص دستوري واضح في مقدمة الدستور، يعترف بسوريا كدولة متعدّدة القوميات والثقافات، ويذكر المكونات الأساسية بالاسم دون تفاضل.
2. تثبيت حماية الحقوق اللغوية والثقافية، عبر مواد ملزمة، تكفل التعليم والإعلام باللغات القومية المحلية.
3. إعادة النظر في الرموز الوطنية (النشيد، الأعياد، المناهج، الخرائط الرمزية…) لتكون شاملة وتمثيلية.
4. اعتماد آليات ديمقراطية للتمثيل السياسي، تمنع الاحتكار القومي أو الطائفي، دون السقوط في المحاصصة.
5. إطلاق حوار وطني تأسيسي، تُدعى إليه المكونات السورية كافة، ليُكتب من خلاله عقد اجتماعي جديد، على أساس الاعتراف والعدالة لا الغلبة والانكار.
أخيراً: السؤال المطروح على السوريين اليوم لم يعد: “هل نعترف بالتعدد؟”، بل:
“هل نريد بناء وطن تتّسع هويته للجميع، أم نُعيد إنتاج دولة تشبه جزءاً منه فقط؟”
الملحق الأول: مفاهيم أساسية مستخدمة في الدراسة
1. المواطنة المتساوية:
مفهوم قانوني يقوم على مبدأ أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو القومية أو الجندرية، لكنه لا يعني إلغاء الاختلافات الثقافية، بل حمايتها ضمن إطار قانوني واحد.
2. التعدّد القومي:
هو الاعتراف بوجود أكثر من جماعة قومية داخل الدولة، لكل منها خصوصيتها الثقافية واللغوية والتاريخية، وهو يختلف عن الفدرالية القومية، حيث يمكن أن يُعترف بهذا التعدّد ضمن دولة موحّدة غير فدرالية.
3. المحاصصة:
نظام يقوم على توزيع المناصب والسلطات بحسب الانتماءات الطائفية أو القومية، كما في لبنان والعراق، وغالباً ما يؤدّي إلى تجميد الحياة السياسية وتقوية الهويات الجزئية، إذا لم يُدار بحكمة.
4. القيادة الأخلاقية للأغلبية:
هي استعداد الأغلبية العددية أو الرمزية للمبادرة بالاعتراف بالآخرين وحمايتهم، ليس من موقع الضعف، بل من موقع القدرة والمسؤولية.
5. الدولة التوافقية مقابل الدولة القومية الأحادية:
الدولة التوافقية تقوم على التعدّد والتوازن بين المكونات، بينما تقوم الدولة القومية الأحادية على افتراض وجود “أمّة واحدة” وهوية مركزية تفرض على الجميع، وتُقصي الهويات الأخرى.
الفرق بين الاعتراف بالتعدد والمحاصصة
يخلط الكثير من الفاعلين في النقاش السوري بين الاعتراف بالتعدد والمحاصصة، رغم أنهما مفهومان مختلفان جذريا.
الاعتراف بالتعدد
المحاصصة
يعترف بالهويات كواقع ثقافي وتاريخي ضمن الدولة
يوزع السلطة والموارد على أساس الانتماء
لا يمنع التنافس الديمقراطي والانتخابي
يجمّد الحياة السياسية ويُضعف الأحزاب العابرة للهويات
يحمي المكونات لغويًا وثقافيًا وتعليميًا
يُركّز على التمثيل في المناصب السيادية
يعزز الشعور بالمواطنة عبر الإنصاف
يُغذّي الانقسامات إذا غابت المواطنة العامة
الاعتراف بالتعدد هو اعتراف بالحقوق والوجود، أما المحاصصة فهي تقاسم للسلطة والمكاسب.
البند
نموذج المحاصصة الجامدة
نموذج الشراكة الديمقراطية التعددية
التمثيل السياسي
مخصص مسبقًا لكل مكوّن (حصص)
مفتوح لكن مكفول عبر قوانين انتخاب تضمن الشمول
تعيين المسؤولين
عبر الانتماء القومي أو الطائفي
بالكفاءة مع ضمان التعدد واللا مركزية
استقرار النظام
هش ومتقلب بسبب التفاوض المستمر على الحصص
أكثر مرونة ويعتمد على المشاركة لا الحصص
ولاء المواطنين
للهوية الفرعية غالبًا
للهوية الوطنية التي تعترف بالجميع
الملحق الثاني: نماذج دستورية مقارنة للاعتراف بالتعدد
يظهر هذا الملحق كيف تعاملت بعض الدساتير المقارنة — في بلدان ذات تعدّدية قومية أو دينية أو لغوية — مع مسألة الاعتراف بالتنوّع داخل الدولة، بشكل يوازن بين مبدأ المواطنة المتساوية والحاجة إلى حماية الهويات الثقافية.
1. دستور العراق (2005): المادة 3
“العراق بلدٌ متعدّد القوميات والأديان والمذاهب، وهو جزء من العالم الإسلامي، ويضمن هذا الدستور كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية…”
❖ الدلالة: اعتراف صريح بالتعدّد كمكوّن بنيوي في الدولة، وتثبيت للتنوّع لا باعتباره استثناء بل قاعدة تأسيسية.
❖ الملاحظة: رغم أن العراق سقط في فخ المحاصصة، فإن نصوص الدستور ذاتها تُعد منفتحة على التعدّد دون اشتراط نموذج تقاسمي محدّد.
2. دستور جنوب إفريقيا (1996): المادة 1 والديباجة
“تبنى جمهورية جنوب إفريقيا على أساس: الكرامة الإنسانية، والمساواة، وحقوق الإنسان والحريات، وديمقراطية تعدّديّة، واحترام التنوّع…”وفي الديباجة: “نحن شعب جنوب إفريقيا، متّحدون في تنوّعنا… نسعى إلى بناء مجتمع ديمقراطي عادل وشامل.
❖ الدلالة: جعل التعدّد جزءاً من القيم المؤسسة للدولة، كبديل عن الدولة العرقية التي سبقتها.
❖ الخصوصية: اعتمد الدستور أحدى عشرة لغة رسمية، وأقرّ تمثيلاً ثقافياً متكافئاً دون محاصصة سياسية.
3. دستور إسبانيا (1978): المادة 3 والمادة 2
“اللغة القشتالية هي اللغة الإسبانية الرسمية للدولة، وتتمتّع اللغات الأخرى بحقوق رسمية في مناطقها…”
والمادة 2 تنص على: “تعترف الدولة وتضمن حق الحكم الذاتي للقوميّات والمناطق التي تؤلّفها.”
❖ الدلالة: اعتراف دستوري بالتعدّد القومي (الكتالوني، الباسكي، الغاليثي…) ضمن دولة واحدة.
❖ التجربة: رغم توترات لاحقة، لا تزال صيغة “دولة متعدّدة الأمم” قائمة على أساس قانوني محترم.
4. الدستور الكندي (1982): ميثاق الحقوق والحريات
“يُفسَّر هذا الميثاق بطريقة تحترم الحفاظ على التعدّد الثقافي الكندي.”
كما يعترف بحقوق الشعوب الأصلية والفرنكوفونيين (الفرنسيين في كيبيك).
❖ الدلالة: حماية حقوق الأقليات الثقافية واللغوية، مع ضمان الاعتراف التاريخي.
❖ التجربة: لم يُؤد الاعتراف بالتعدّد إلى تفكّك الدولة، بل إلى استقرار نسبي واستيعاب سياسي للنزاعات.
5. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966): المادة 27
“لا يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية، حرمان الأشخاص المنتمين إلى هذه الأقليات من حقهم في التّمتّع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم أو استعمال لغتهم.”
❖ الدلالة: قاعدة دولية ملزمة تؤكّد أن احترام التعدّد ليس خياراً سياسياً بل واجب قانوني دولي.
❖ الاستفادة السورية: يمكن اعتماد المادة 27 مرجعية في الدستور الجديد، وربطها بمبادئ حقوق الإنسان.
الملحق الثالث: خرائط تقديرية لتوزيع المكونات القومية والدينية في سوريا.
رغم غياب إحصاءات رسمية محدّثة وموثوقة منذ إحصاء عام 1960، إلا أن الدراسات الأكاديمية والتقارير الحقوقية والاجتماعية تتيح رسم خريطة تقديرية لتوزّع المكونات القومية والدينية في سوريا، لا تهدف هذه الخرائط إلى تعزيز الانقسامات أو إثبات “ملكية جغرافية”، بل إلى فهم واقعي لتركيبة المجتمع السوري، يساعد في تصميم سياسات الاعتراف والمواطنة المتساوية، تستند هذه التقديرات إلى مصادر بحثية وتقارير ميدانية متعددة، ولا تمثّل أرقاماً نهائية بقدر ما تعكس تصوراً مركباً لتوزّع المكونات في سوريا.”
1. العرب (سنة، علويون، إسماعيليون، دروز)
النسبة التقريبية: 80–85% من السكان.
التوزيع:
العرب السنة: الغالبية السكانية في معظم المدن الكبرى (دمشق، حلب، حمص، دير الزور، درعا).
العلويون: سواحل اللاذقية وطرطوس وريف حمص الغربي.
الدروز: السويداء وجبل العرب.
الإسماعيليون: ريف سلمية (محافظة حماة) وبعض قرى طرطوس.
الملاحظات:
رغم الأغلبية العددية، فإن العرب يتوزّعون على طيف واسع من الانتماءات المذهبية والسياسية.
التمثيل السياسي الحقيقي للأغلبية لم يكن متناسباً مع عددها في ظل حكم شمولي.
2. الكرد
النسبة التقريبية: 8–10%
المراكز الجغرافية:
القامشلي، عامودا، الدرباسية، رأس العين، عين العرب (كوباني)، عفرين.
بعض الأحياء في دمشق وحلب (حي الأشرفية – الشيخ مقصود).
الملاحظات:
الكرد يشكّلون غالبية سكانية واضحة في بعض المناطق،
يعانون من إرث ثقيل من التهميش الإداري والثقافي، وتجريد قسم كبير منهم من الجنسية حتى عام 2011.
3. السريان والآشوريون
النسبة التقريبية: أقل من 1%
التوزيع:
الحسكة، القامشلي، تل تمر، المالكية.
بعض الوجود التاريخي في حمص، حلب، ودمشق.
الملاحظات:
لغتهم الأصلية هي السريانية (أو الآرامية).
يطالبون غالباً بحقوق ثقافية ولغوية دون ميل للانفصال.
4. الأرمن
النسبة التقريبية: 1–1.5%
التوزيع:
حلب (حي الميدان، النُزْهَة)، دمشق، كسب، حمص.
الملاحظات:
لديهم مدارس ومؤسّسات ثقافية، ويملكون هوية قوية مرتبطة بالشتات الأرمني.
يطالبون بالاعتراف الثقافي واللغوي، ويُعتبرون من المكونات الأقل توتّراً سياسياً.
5. التركمان
النسبة التقريبية: 2–3%
التوزيع:
مناطق في ريف اللاذقية، حلب (اعزاز، الباب، جرابلس)، حمص (تلبيسة).
الملاحظات:
لغتهم تركية، وغالباً ما تم إقصاؤهم من المشهد الرسمي الثقافي،
واجهوا صعوبة في التعبير عن هويتهم بسبب ارتباطهم الإقليمي بتركيا.
6. الشركس والشيشان
النسبة التقريبية: أقل من 1%
التوزيع:
دمشق (مساكن برزة)، القنيطرة، حماة، الجولان.
الملاحظات:
جماعات جاءت من القوقاز في القرن 19، واحتفظت بهويتها الثقافية،
يطالبون غالباً بحقوق ثقافية دون طموحات سياسية منفصلة.
الملحق الرابع: جدول مقارنة بين الصياغات الدستورية الممكنة
يُظهر هذا الملحق المقارن كيف تؤثر صياغة النص الدستوري في إنتاج المعنى السياسي والرمزي داخل الدولة، ففي قضايا التّعدّد القومي والديني، ليس فقط ما يُقال هو المهم، بل كيف يُقال، وما يُسكت عنه أيضاً،
لذلك، نقدّم هنا جدولي مقارنةً بين:
الصياغات الأحادية أو الإقصائية والصياغات التعددية الجامعة التي تعكس عدالة وشراكة.
البند
الصيغة الإقصائية (مهيمنة)
الصيغة التعددية الجامعة
ديباجة الدستور
سوريا جزء من الأمة العربية…
سوريا دولة ديمقراطية متعددة القوميات والثقافات…
تعريف الهوية الوطنية
قومية عربية مركزية
هوية وطنية مركبة تعترف بالمكونات كافة
اللغة الرسمية
العربية فقط
العربية + الاعتراف بلغات وطنية (كردية، سريانية، أرمنية…)
الاعتراف بالتعدد
يتم تجاهله أو إنكاره
يُقر بوصفه غنى ثقافي ومبدأ تأسيسي
ضمان الحقوق الثقافية
غير مذكور أو يخضع للسلطة التنفيذية
مكفولة في الدستور بقوة قانونية
الرموز الوطنية
من ثقافة واحدة
تمثل تنوع المجتمع السوري
عبد القادر موحد
المراجع العربية :
العروي، عبد الله. مفهوم الدولة. الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 1981.
بشارة، عزمي. المسألة العربية: مقدمة لبيان ديمقراطي عربي. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2007.
الحافظ، ياسين. اللاعنف والثورة. بيروت: دار الحقيقة، 1973.
المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية. مستقبل الحكم المحلي في سوريا. واشنطن/غازي عنتاب: المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية، 2016.
دستور الجمهورية التونسية. 26 يناير 2014. https://www.constituteproject.org/constitution/Tunisia_2014.pdf
دستور جمهورية العراق. 2005. http://iraqld.hjc.iq/LoadLawBook.aspx?SC=240520058956063
المراجع الأجنبية :
Kymlicka, Will. Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights. Oxford: Oxford University Press, 1995.
Keating, Michael. Nations Against the State: The New Politics of Nationalism in Quebec, Catalonia and Scotland. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2001.
Deng, Francis M. National Identity and Self-Determination: The African Perspective. Washington, D.C.: Brookings Institution, 1996. https://www.brookings.edu/articles/national-identity-and-self-determination/
Ghai, Yash. Public Participation and Minorities. London: Minority Rights Group International, 2003.
Constitution of the Republic of South Africa, 1996. https://www.gov.za/documents/constitution-republic-south-africa-1996
Canadian Charter of Rights and Freedoms, 1982. https://www.justice.gc.ca/eng/csj-sjc/rfc-dlc/ccrf-ccdl/index.html
International Covenant on Civil and Political Rights. 1966. https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
مكتب الدراسات والشؤون القانونية في حزب الوطن السوري